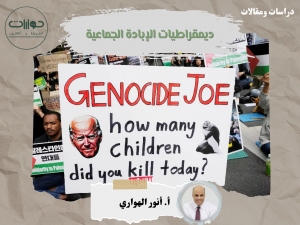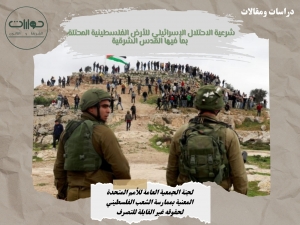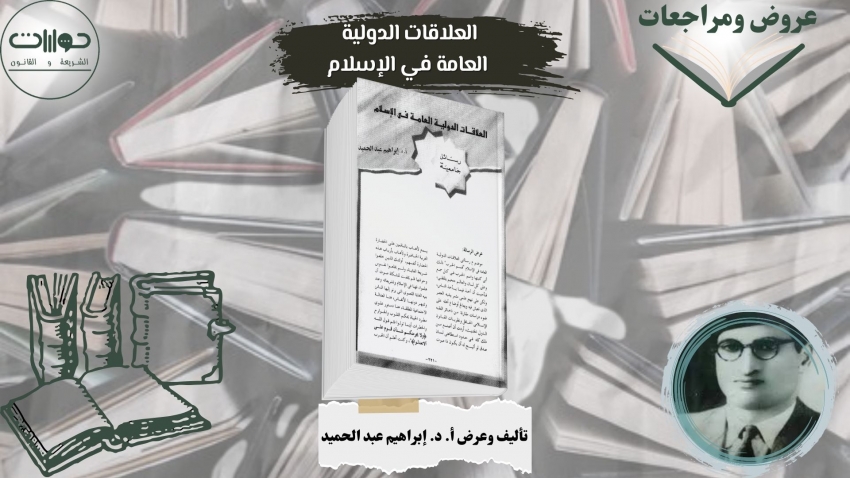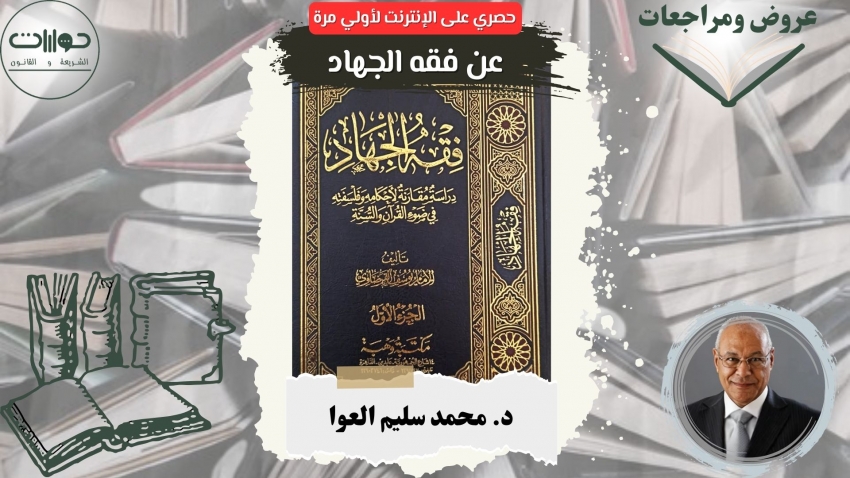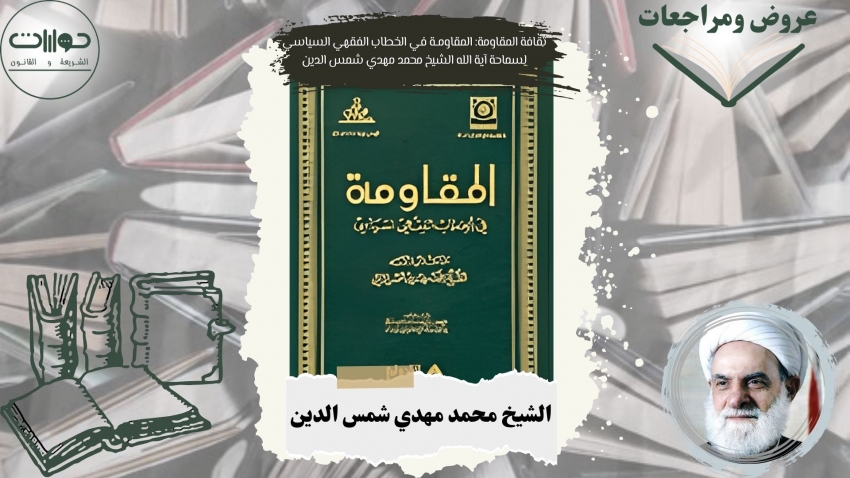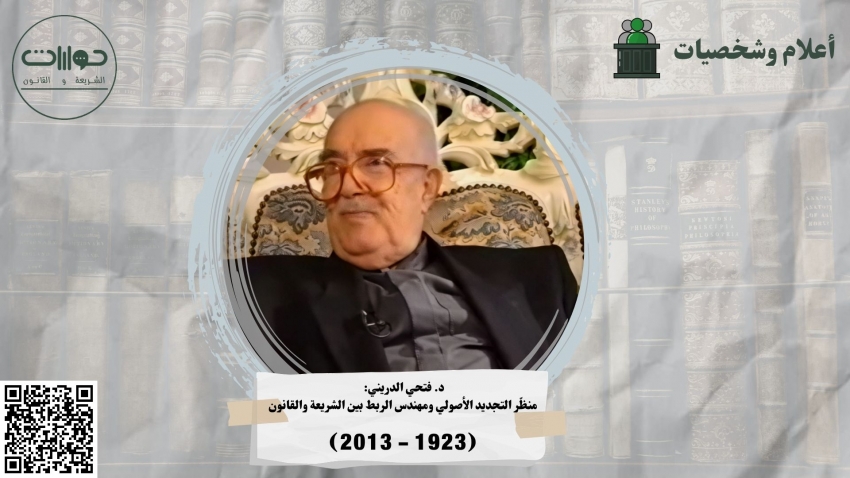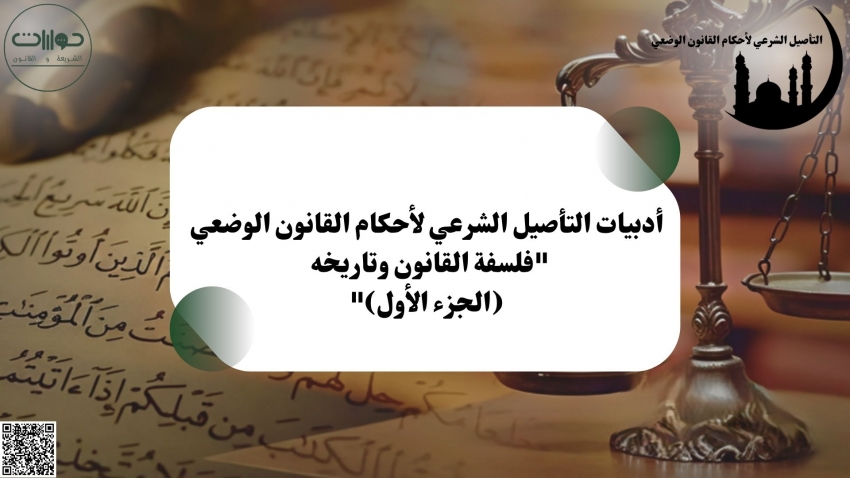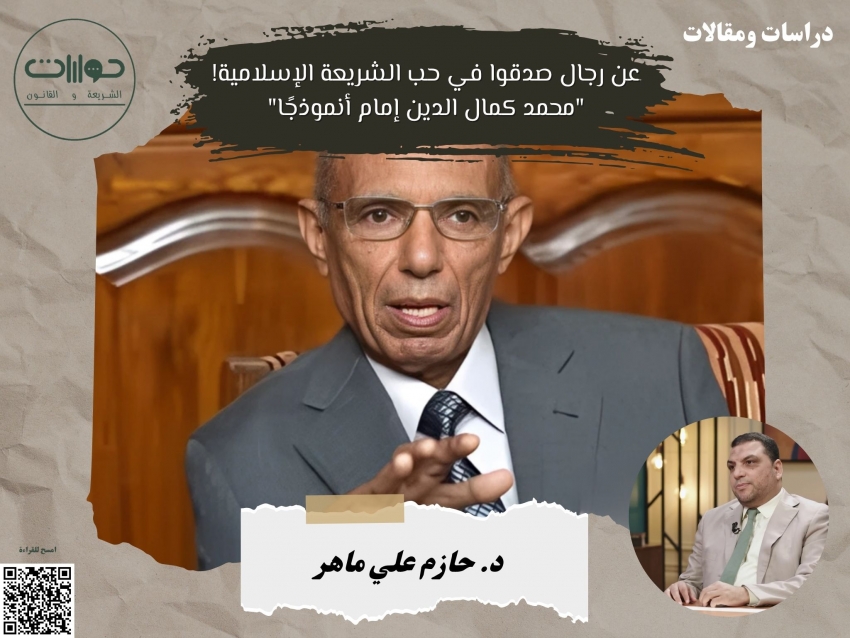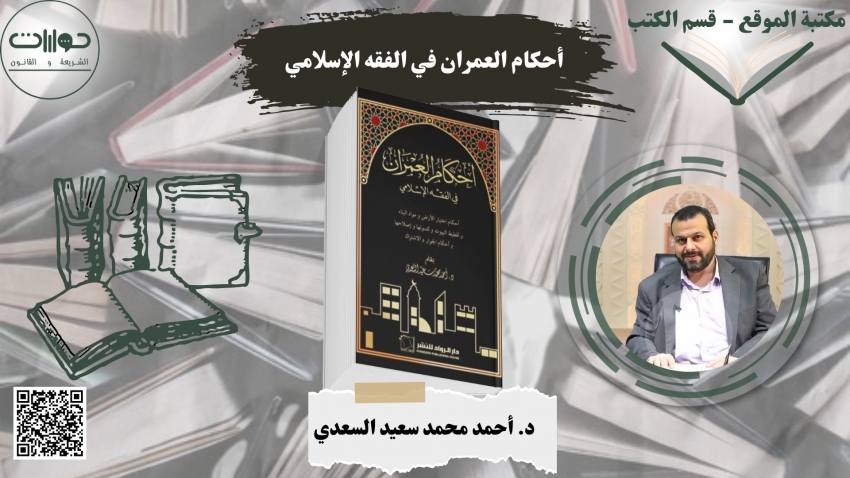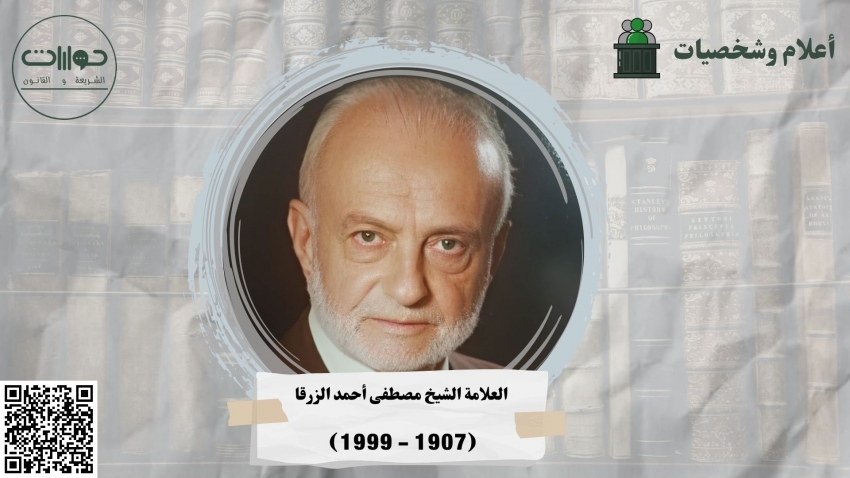في ظل العدواني الصهيوني الجاري والجائر على أهل غزة، وما يمارسه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل بلا أي رادع أو متصد سوى المقاومة الفلسطينية في غزة بما مكنها الله به من أدوات وخطط وبخالص سواعدها وبصدق نيتها وقوة عزيمتها وصلابة إرادتها وصبرها ورباطها على الحق وردع الظلم؛ تحوطهم من خلفهم دعوات المسلمين.
فقد رأينا أنه من واجبنا ومن واقع عملنا أن نعد ملفًا يضم ما نشره الموقع من مادة علمية اعتنت بالمقاومة الفلسطينية من زاوية اهتمام الموقع، والتي استهدفت دراسة الأبعاد القانونية والتشريعية والمفاهيمية للصراع الفلسطيني (والعربي والإسلامي) الصهيوني بصفة عامة، والعدوان على غزة بصفة خاصة.
وجاءت محتويات الملف، على النحو الآتي:
أولا: في باب "مصطلحات ومفاهيم"
1. مفهوم المقاومة المسلحة، https://2u.pw/2JvShSi.
2. القانون الدولي الإنساني، https://2u.pw/ewrDLgx.
3. جريمة إبادة الجنس البشري (الإبادة الجماعية)، https://2u.pw/OCgUImO.
4. مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي,https://bit.ly/3Adqt8k
5. جريمة التجويع, https://bit.ly/3YkceH8
6. حق الدفاع عن النفس.. مفهومه وشروطه في القانون الدولي, https://bit.ly/4dOcpjD
7. الدروع البشرية, https://bit.ly/3UgGS2V
8. الاستدمار الاستيطاني, https://bit.ly/3A3pBTU
ثانيا: في باب "دراسات ومقالات"
1. مشروعية المقاومة الفلسطينية، للأستاذة الدكتورة عائشة راتب، https://2u.pw/TMqB3Yj.
2. وثيقة: مفهوم الإرهاب والمقاومة… رؤية عربية – إسلامية، https://2u.pw/iePgZjw.
3. "الإرهاب في القانون الدولي والشريعة الإسلامية.. إشكالية المفهوم" للدكتور حازم علي ماهر، https://2u.pw/6IjY38R.
4. التدخل الدولي لمصلحة الشعوب بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة "دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية" د. عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد، https://2u.pw/qOGqfbW.
5. العدوان على غزة ... الحرب الثانية عشر، المستشار طارق البشري، https://2u.pw/tFaZieP
6. رؤية قانونية: القانون الدولي والمقاومة، د. محمد شوقي عبد العال، https://2u.pw/00GBTla.
7. الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، د. أحمد أبو الوفا، https://2u.pw/U727Utt.
8. إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانونٍ مهمش، غسان الكحلوت-مني هدية، https://2u.pw/khOCwun.
9. المركز القانوني الدولي لحركات المقاومة في القانون الدولي المعاصر، د. هيثم موسي حسن، https://2u.pw/WKAX1dX.
10. انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولي في فلسطين، أ. كيران لمياء، https://2u.pw/da7WwhG.
12. الحدود بين الإرهاب الدولي وحركات التحرر الوطني "وفقًا لأحكام القانون الدولي"، د. رمزي حوحو، https://2u.pw/PtCvYpB
13. إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة الفلسطينية)، الدكتورة آمنة أمحمدي بوزينة، https://2u.pw/DWyV8RB
14. هل تملك محكمة العدل الدولية وقف حرب غزة؟! "قراءة في فاعلية التدابير المؤقتة"، https://2u.pw/dG6cI30.
15. ثنائية المدني والعسكري بين الفقه والقانون الدولي، https://2u.pw/eQ8Fjm4.
16. أنور الهواري، ديمقراطية الإبادة الجماعية، https://2u.pw/hJ9tG4J
17. شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية, https://bit.ly/3YuAjvV
18. قضية الإبادة الجماعية في غزة: ملخص شامل لمعركة جنوب أفريقيا القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ... ملخص القضية والأسئلة الشائعة, https://bit.ly/3BL7xhG
19. التعويل على محكمة العدل الدولية.. بين التهوين والتهويل!, https://bit.ly/4eNq63C
ثالثا: في باب "الرسائل العلمية"
1. رسالة ماجستير بعنوان "الحصار وأثره على حقوق الإنسان: دراسة مقارنة بين الفكر الإسلامي والقانون الدولي- غزة نموذجًا"، للباحث سعيد العابد، https://2u.pw/OMgNslO.
2. الجرائم الواقعة على أسرى الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي- دراسة تأصيلية تطبيقية، للباحث عمر نسيل، https://2u.pw/dlPNtjW.
3. العنف الدولي وحق الشعوب في المقاومة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام، للباحثة صباح درامنة، https://hewarat.org/?p=4862.
4. حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي: حالة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ممدوح محمد يوسف، https://2u.pw/lxfZlb6.
5. استخدام القوة في العلاقات الدولية بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية، نوري صباح حميد، https://2u.pw/ESfDIMJ.
6. حماية الأفراد والأعيان المدنية أثناء النزاع المسلح في الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، أحمد سليمان أبكر، https://2u.pw/LRDmuv5.
7. المبادئ العامة الدولية والإنسانية في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"، مساعد راشد العنزي، https://2u.pw/9VPL5mR.
8. حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي في ظل مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام القانون الدولي الإنساني- دراسة مقارنة، حجاب نصر الدين، https://2u.pw/0CQaBjk.
9. حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، د. باسم خلف العساف، https://2u.pw/sNv9mIj.
10. حماية ضحايا النزاع المسلح الدولي في ظل مبادئ الفقه الإسلامي وأحكام القانون الدولي الإنساني- دراسة مقارنة، حجاب نصر الدين، https://2u.pw/0CQaBjk
11. المبادئ العامة الدولية والإنسانية في النزاعات المسلحة "دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية"، مساعد راشد العنزي، https://2u.pw/9VPL5mR
12، مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية: دراسة تأصيلية، عايض بن عبد العالي الشلوي، https://2u.pw/djecgul
13. حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، د. باسم خلف عبدربه العساف، https://2u.pw/sNv9mIj
رابعا: باب "الكتب"
1. حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام في الفلسفة السياسية والقانون الوضعي، للأستاذ الدكتور محمد طه بدوي، https://2u.pw/5uN0I14.
2. الأسانيد القانونية لحركات المقاومة في القانون الدولي، د. مصطفي أبو الخير، https://2u.pw/QUnTitu.
3. كتاب "كيف نقاضي إسرائيل؟"، د. سعيد طلال الدهشان، https://2u.pw/NDR4YVS.
4. مبدأ الضرورة العسكرية في الفقه الإسلامي وفي القانون الدولي الإنساني، بوبكر مصطفاوي، https://2u.pw/KkUTDBB
خامسًا: باب "الأخبار والتقارير"
1. ندوة «النزاع الحالي في غزة»: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية، جريدة السياسة الكويتية، https://2u.pw/829uoSS.
2. كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟، تي آر تي العربية، https://2u.pw/hrnYbyI.
3. رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي: المقاومة الفلسطينية ليست منظمات إرهابية، دي إم سي المصرية، https://2u.pw/m6BklOT.
4. خبراء قانونيون: القانون الدولي يحمي سلاح المقاومة الفلسطينية، عوض الرجوب، الجزيرة نت، https://2u.pw/L6GPRLN.
5. خبير قانوني: مقاومة الاحتلال حق مكفول في المواثيق الدولية، https://2u.pw/lBSbccK.
6. جدلية المقاومة والإرهاب؛ والفرق بينهما وفق القانون الدولي، https://2u.pw/sYeJNs6.
7. العفو الدولية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي وارتكبت جرائم حرب بغزة، https://2u.pw/QEHuxtG.
8. لجنة تحقيق أممية: الاحتلال الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي، https://2u.pw/xqvRHbI.
9. خبيران قانونيان: حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة، قيس أبو سمرة، https://2u.pw/hx9jGwn.
10. خبيران قانونيان: حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة، قيس أبو سمرة، https://2u.pw/hx9jGwn
11. 7 أسئلة لفهم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، https://2u.pw/4uqb6qg.
سادسا: باب "وثائق وقوانين"
1. نص قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري، https://2u.pw/OffJSHQ.
2. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، https://2u.pw/I7AGmCX.
3. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، https://2u.pw/QaUyZTr.
سابعًا: باب "عروض ومراجعات"
1. حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات، عرض: سمير محمد شحاتة، https://2u.pw/fBtOofE.
2. حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات، عرض: سمير محمد شحاتة، https://2u.pw/fBtOofE
3. ثقافة المقاومة: المقاومــة في الخطاب الفقهي السياسي لسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين, عبده إبراهيم, https://bit.ly/3A6aA3x
ثامنًا: "حوارات وتفاعلات"
1. الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: المقاومة الطوفانية حركة تحرر للإنسان والعالم، عبد الحكيم أحمين، https://2u.pw/O4pp6DZ.
تاسعا: المرئيات،
1. ما هو الأساس الديني في حماية مقدمي الرعاية الصحية في الإسلام؟، https://2u.pw/LFgiTqu
2. هل يتعارض القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية؟، https://2u.pw/f5rHGCR
3. حماية المدنيين والأعيان المدنية وفق الشريعة الإسلامية، https://2u.pw/dAdEuc9
4. معاملة الجرحى والمرضى وفق الشريعة الإسلامية، https://2u.pw/zhVtVSE
5. "طوفان الأقصى وموقف محكمة العدل الدولية" ندوة للدكتور محمد سليم العوا, https://bit.ly/4dYLlOy
وسنقوم بإضافة أي مادة جديدة سينشرها الموقع مجددًا حول موضوع الملف نفسه بإذن الله.